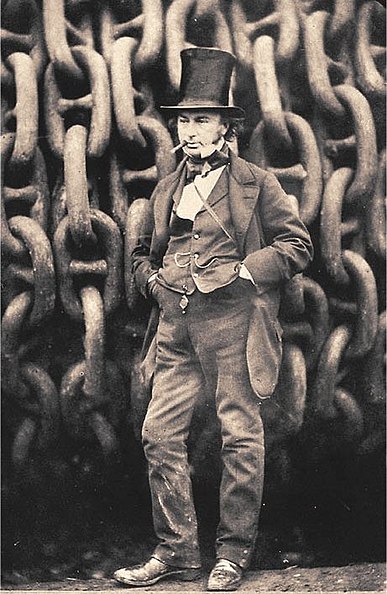لا أظن أن هناك ماهو أكثر ثراءا من الجلوس على البار...
و لا أعني بالبار المكان الذي يبيع الكحول و الجعة ، و إنما أعني تلك المنضدة الطويلة ، التي جمعت شتات أقوام و أزمنه بشكل يصعب تصديقه...
فلم أكن أظن يوما أنني سأخالط القاضي ، و التاجر الاسطوري ، و المصور الأرمني ، و مُدرِّسة الأدب الانجليزي ، و خبير السجائر اليوناني ، و العاطل بالوراثة ، و أصحاب بارات قدامى على طاولة واحدة ، الكل يتجاذبون الحديث ، و لم تفرقهم ثقافاتهم و دياناتهم ، بل و لم تفرقهم الأعمار..
دعاني المصور الأرمني العجوز إلى الاستديو الذي يصور فيه - أو كان يصور فيه -لأشاهد أعماله ، فقد علمت يومها أنه قد خلاه في نفس اليوم بعد ستين عاما من التصوير... شاهدت صورا تم تظهيرها باستخدام أشعة الشمس من الثلاثينات ، و صور تم تلوينها باليد ، و تاريخ حافل للقاهرة عبر مئات الوجوه التي يعرف أصحابها ، و صاحباتها جيدا...
سألته ، مسيو هنري ، ماذا ستفعل بعد إغلاق المكان ... قال بابتسامة ملؤها سلام غريب : حاجي أقعد معاكم هنا...
لم أكن أظن أنه لازال بالامكان إذابة الفوارق الطبيعية ، و الايدلوجية بين أناس عدة ، و تحويل ساعاتهم إلى كم هائل من المزاح ، و النكات ، و الشجار أحيانا ، و الذي يختفي في نفس اليوم ، أو من غده على أقصى تقدير...
بدأ الأمر بصدفة قادتني للجلوس على البار وحدي ، لتأخر ميعاد لي ، و عدم وجود طاولات شاغرة ، فراقني الأمر ، و في المرة التالية اتجهت للبار صوبا، ثم مرت عدة أيام أخالط أهل البار علي على طبيعتي الخجلى ، و لكنني فوجئت بهم يعرفونني بالاسم بعد عدة أيام ، ثم بعد فترات و جدت نفسي في يوم جالس ، فأجد مشروبا ما وضع أمامي ، و أحدهم رفع كأسه من آخر البار على سبيل التحية ، فاضطررت لرفع الكاس ، حتى و إن لم يكن في نيتي الشرب.
حينما أمر بالمكان ، و معي صديق أو صديقة فإنه سرعان ما يجد نفسه جزءا من حوار ، و كأنه يكفي للجالس أن يكون صديقا لأي من أهل البار ، فكأنه منهم ، و الأجمل أنه لا وجود لسؤال : و انت بقى بتعمل إيه ....؟
فلا أحد يهتم جديا بمهنة الآخر أو انجازاته الاسطورية ، و انما يهتم بما يقوله الآن...
و هو شيء أسرني منذ أول وهلة...
اليوم أتى أحدهم بقصاصة من جريدة حكومية تهاجم المواخير بحسب تعبيرها ، و تعتبرها (وكرا للشياطين) و المؤسف أن من أتي بالقصاصة كانت صورته في قلب التحقيق ، و هو جالس في بار ما ، و يدخن السيجار ، و على وجهه شريط أسود ، ألقاها لنا بوجوم قائلا... بقيت زي المجرمين..
تناقلت الأيدي القصاصة ، و الكل يطلق دعابة ما ، و ما انفك الامر إلا أن تحول إلى حزمة ضخمة من النكات تطلق على الصحيفة ، و الزمن ، و الشيخ الذي كتب المقال، و الشرطة ، و الحكومة ، و حتى صاحبنا ذلك نفسه الذي تركهم و ذهب لهذا البار وحده.. فابتسم الرجل أخيرا ، و طلب بيرته.
أحدهم كان رجلا كبيرا و سمينا جدا ، لاحظت أنه يلعب السودوكو ، اشترى كتابا ضخما للعبة ، و ظل يلعب ... قمت في يوم بتجميع قصاصات السودوكو من جريدة الحياة ، أطيتها إياه ، و في اليوم التالي قال: خلصتهم!
علمت أنه كان محاسبا ذا شأن في الستينات... لذا فالأرقام لعبته كما يقول الزملاء.
و الغريب أن الفتيات أيضا اللائي اعتدن إتيان هذه الطاولة ، أصبحن جزءا من سياق الحديث ، و غالبا ما يعاملن بحنان و إجلال من الجميع ، و رغم حداثة سن بعضهن إلا أنني لم أسمع يوما أي كلمة في الحكم عليهن أو الذم في سلوكهن ، علما بأنني كنت دوما أرى أن الفتاة التي تدخل مكانا لتجلس على البار دونا عن الطاولات ،هي حتما حولها إن!
و قد حدث أن جلس شاب و شابة أوروبيان بين أهل البار كيفا أتفق ، و حدث أن تبادلا قبلة طويلة جدا ، لا حظت أن غالبية زبائن المكان شعروا بتوتر ما ، و كان الناس من الطاولات ينظرون و كأنه عرض للسيرك ، باستثناء الجالسين على البار بجوارهم ، حتى أن أحد النادلين ، أراد أن يفعل شيئا فاقترب من الشابين ، فإذا بأحد الجالسين علي البار قد لاحظه ، و رفع له إصبعه منبها إياه بلا أية كلمات ، و كأنه يقول : سيبهم فب حالهم.
أما البارمان ، ذلك الذي يرتدي زي المكان المتكلف ، فإنه في أحد المرات كان يحدثني عن الفرق بين أنواع الوسكي ، و أخبرني أن منه السكوتش الأصلي ، أو البليند ، و عن الفرق بينهما و بين النوع المصري - الرجل صعيدي الأصل -سمعته باهتمام رغم أنني لا أشرب الويسكي، و كنت أفكر: هل كان هذا الرجل يعلم و هو بعد طفلا في قريته ،أنه في يوم ما سيكون واقف ها هنا يحاضر في الويسكي أمام أئمة الشاربين؟
و تعجبت أكثر حينما تبرعت يوما لإيصاله لبيته في حيه الشعبي ، مرتديا جلابيته الصعيدية الواسعة.. و كأنه لم يكن أبدا واقفا في البار و كأنه لم يكن بكل هذا التأنق.
حكيت له يوما قصة قديمة حدثت لي :" كنت مرة في لندن ، و كنت وحدي ، و لدي بعض الوقت ، فدخلت بار أيرلندي ، جلست على البار -عكس عادتي ، لكن أردت أن أفعل كما في الأفلام - و جدت فتاة زرقاء العيون خاطفة للأنفاس ، سألتني بلكنتها اللندنية: ماذا أجلب لك؟ ، و الحقيقة كنت قد شاهدت من حولي أناس يشربون بيرة حمراء و سوداء و خضراء ، و هي أنواع لم أشاهدها في مصر ، و كنت أجهل أسماء تلك الأشياء ، فقلت لها ببراءة : أنا من القاهرة ، هناك أشرب الستلا ، و لكنني هنا أشاهد أنواعا أخرى ، هل لي في تجربة إحداها؟
- ستلا؟ هي لاجر بير؟
- أظن ذلك ، لكني أريد شيئا مغايرا ، مثل ما يشربه أولئك الناس هناك...
- يا سيدي ، لن أستطيع أن أحضر لك شيئا تجهله ، ماذا إن لم يعجبك ؟
- إننا ندفع بالمقدم ، سأدفع أيا كان ، لكني أريد شيئا مختلفا...
- مثل ماذا؟
- لا أعلم الأسماء فقط فاجئيني...
نظرت لي مطولا ، ثم غابت قليلا ، و عادت بكأس من بيرة صفراء ...
قلت: ماهذا؟؟
قالت: ستلا... "
ضرب الرجل كفا بكف و أكد لي أنها لا تفهم في أصول و اتيكيت البارات ، قالها بلكنته الصعيدية ، و لكنه كان أكثر إقناعا من الفتاة في قلب لندن....
قارنت مقارنة عبثية ،فكرت أن هناك أصدقاء لي من شباب الفنانين الجدد، أو فتيان و فتيات الجامعة الأمريكية و ما عداها ، أشعرغالبا و أنا بينهم أنهم لا علاقة لهم بواقع هذه البلاد ، لا يعرفون شيئا عما حدث أو يحدث ، و الكل غارق في معاناته ، أفكاره الذاتية.. (و لا غبار على ذلك إطلاقا)
و لكن الغريب أن رجال البار هؤلاء ، أيضا ، لا علاقة لهم بما يحدث خارج هذا الباب ، العالم إن قام و نام ، فهم لازالوا هنا ، يطلقون النكات ، و يغيرون الموسيقى... و لكن الفرق الوحيد أن زملاء البار يعكسون شيئا منا جميعا..
ليس لأنهم من ماض بعيد ، على العكس فمنهم شبان و شابات ، و لكن لكل هذه التعددية ، و الاختلاف و القبول في آن واحد ، في مكان واحد... يتحدثون لغة هي خليط بين لغتي أنا و لغة أبي و أمي ، لغة سفهاء البلاد و أبطالها ، لغة الفتاة التي أحب ، و لغة الفتاة التي أكرهها ... يتحدثون العامية التي تتخللها الفصحي ، و فرنسية مفهومة ، و انجليزية غاية في التعقيد ، و ربما شذرات من أرمنية أو يونانية... و لا مجال للثقافة هنا..
روى أحدهم نكتة" صليب سيدنا محمد" الشهيرة ، فضحك الحضور على اختلاف دياناتهم و مشاربهم ، و رد آخر بنكتة نكاية في الأقباط ، و ضحك الجميع أيضا ، و الحق كنت أعرف أن نصف الجلوس على الاكثر مسلمين ، و النصف الآخر من ملل و نحل أخري ، و الحق لم أعرف أيهم من و أيهم من ...
قبل انصرافي في أحد المرات ، قال لي أحدهم ... درينك سريع يا أحمد بيه؟ (الكل بيه هناك) ... و صب لي سائلا ما لا أشربه ، رفعت الكأس و قلت في صحة البار.... لم يسألني أحد ماذا أعني ، لم يعلق أحد، فقط ، شربوا النخب في سلاسة
و لا أعني بالبار المكان الذي يبيع الكحول و الجعة ، و إنما أعني تلك المنضدة الطويلة ، التي جمعت شتات أقوام و أزمنه بشكل يصعب تصديقه...
فلم أكن أظن يوما أنني سأخالط القاضي ، و التاجر الاسطوري ، و المصور الأرمني ، و مُدرِّسة الأدب الانجليزي ، و خبير السجائر اليوناني ، و العاطل بالوراثة ، و أصحاب بارات قدامى على طاولة واحدة ، الكل يتجاذبون الحديث ، و لم تفرقهم ثقافاتهم و دياناتهم ، بل و لم تفرقهم الأعمار..
دعاني المصور الأرمني العجوز إلى الاستديو الذي يصور فيه - أو كان يصور فيه -لأشاهد أعماله ، فقد علمت يومها أنه قد خلاه في نفس اليوم بعد ستين عاما من التصوير... شاهدت صورا تم تظهيرها باستخدام أشعة الشمس من الثلاثينات ، و صور تم تلوينها باليد ، و تاريخ حافل للقاهرة عبر مئات الوجوه التي يعرف أصحابها ، و صاحباتها جيدا...
سألته ، مسيو هنري ، ماذا ستفعل بعد إغلاق المكان ... قال بابتسامة ملؤها سلام غريب : حاجي أقعد معاكم هنا...
لم أكن أظن أنه لازال بالامكان إذابة الفوارق الطبيعية ، و الايدلوجية بين أناس عدة ، و تحويل ساعاتهم إلى كم هائل من المزاح ، و النكات ، و الشجار أحيانا ، و الذي يختفي في نفس اليوم ، أو من غده على أقصى تقدير...
بدأ الأمر بصدفة قادتني للجلوس على البار وحدي ، لتأخر ميعاد لي ، و عدم وجود طاولات شاغرة ، فراقني الأمر ، و في المرة التالية اتجهت للبار صوبا، ثم مرت عدة أيام أخالط أهل البار علي على طبيعتي الخجلى ، و لكنني فوجئت بهم يعرفونني بالاسم بعد عدة أيام ، ثم بعد فترات و جدت نفسي في يوم جالس ، فأجد مشروبا ما وضع أمامي ، و أحدهم رفع كأسه من آخر البار على سبيل التحية ، فاضطررت لرفع الكاس ، حتى و إن لم يكن في نيتي الشرب.
حينما أمر بالمكان ، و معي صديق أو صديقة فإنه سرعان ما يجد نفسه جزءا من حوار ، و كأنه يكفي للجالس أن يكون صديقا لأي من أهل البار ، فكأنه منهم ، و الأجمل أنه لا وجود لسؤال : و انت بقى بتعمل إيه ....؟
فلا أحد يهتم جديا بمهنة الآخر أو انجازاته الاسطورية ، و انما يهتم بما يقوله الآن...
و هو شيء أسرني منذ أول وهلة...
اليوم أتى أحدهم بقصاصة من جريدة حكومية تهاجم المواخير بحسب تعبيرها ، و تعتبرها (وكرا للشياطين) و المؤسف أن من أتي بالقصاصة كانت صورته في قلب التحقيق ، و هو جالس في بار ما ، و يدخن السيجار ، و على وجهه شريط أسود ، ألقاها لنا بوجوم قائلا... بقيت زي المجرمين..
تناقلت الأيدي القصاصة ، و الكل يطلق دعابة ما ، و ما انفك الامر إلا أن تحول إلى حزمة ضخمة من النكات تطلق على الصحيفة ، و الزمن ، و الشيخ الذي كتب المقال، و الشرطة ، و الحكومة ، و حتى صاحبنا ذلك نفسه الذي تركهم و ذهب لهذا البار وحده.. فابتسم الرجل أخيرا ، و طلب بيرته.
أحدهم كان رجلا كبيرا و سمينا جدا ، لاحظت أنه يلعب السودوكو ، اشترى كتابا ضخما للعبة ، و ظل يلعب ... قمت في يوم بتجميع قصاصات السودوكو من جريدة الحياة ، أطيتها إياه ، و في اليوم التالي قال: خلصتهم!
علمت أنه كان محاسبا ذا شأن في الستينات... لذا فالأرقام لعبته كما يقول الزملاء.
و الغريب أن الفتيات أيضا اللائي اعتدن إتيان هذه الطاولة ، أصبحن جزءا من سياق الحديث ، و غالبا ما يعاملن بحنان و إجلال من الجميع ، و رغم حداثة سن بعضهن إلا أنني لم أسمع يوما أي كلمة في الحكم عليهن أو الذم في سلوكهن ، علما بأنني كنت دوما أرى أن الفتاة التي تدخل مكانا لتجلس على البار دونا عن الطاولات ،هي حتما حولها إن!
و قد حدث أن جلس شاب و شابة أوروبيان بين أهل البار كيفا أتفق ، و حدث أن تبادلا قبلة طويلة جدا ، لا حظت أن غالبية زبائن المكان شعروا بتوتر ما ، و كان الناس من الطاولات ينظرون و كأنه عرض للسيرك ، باستثناء الجالسين على البار بجوارهم ، حتى أن أحد النادلين ، أراد أن يفعل شيئا فاقترب من الشابين ، فإذا بأحد الجالسين علي البار قد لاحظه ، و رفع له إصبعه منبها إياه بلا أية كلمات ، و كأنه يقول : سيبهم فب حالهم.
أما البارمان ، ذلك الذي يرتدي زي المكان المتكلف ، فإنه في أحد المرات كان يحدثني عن الفرق بين أنواع الوسكي ، و أخبرني أن منه السكوتش الأصلي ، أو البليند ، و عن الفرق بينهما و بين النوع المصري - الرجل صعيدي الأصل -سمعته باهتمام رغم أنني لا أشرب الويسكي، و كنت أفكر: هل كان هذا الرجل يعلم و هو بعد طفلا في قريته ،أنه في يوم ما سيكون واقف ها هنا يحاضر في الويسكي أمام أئمة الشاربين؟
و تعجبت أكثر حينما تبرعت يوما لإيصاله لبيته في حيه الشعبي ، مرتديا جلابيته الصعيدية الواسعة.. و كأنه لم يكن أبدا واقفا في البار و كأنه لم يكن بكل هذا التأنق.
حكيت له يوما قصة قديمة حدثت لي :" كنت مرة في لندن ، و كنت وحدي ، و لدي بعض الوقت ، فدخلت بار أيرلندي ، جلست على البار -عكس عادتي ، لكن أردت أن أفعل كما في الأفلام - و جدت فتاة زرقاء العيون خاطفة للأنفاس ، سألتني بلكنتها اللندنية: ماذا أجلب لك؟ ، و الحقيقة كنت قد شاهدت من حولي أناس يشربون بيرة حمراء و سوداء و خضراء ، و هي أنواع لم أشاهدها في مصر ، و كنت أجهل أسماء تلك الأشياء ، فقلت لها ببراءة : أنا من القاهرة ، هناك أشرب الستلا ، و لكنني هنا أشاهد أنواعا أخرى ، هل لي في تجربة إحداها؟
- ستلا؟ هي لاجر بير؟
- أظن ذلك ، لكني أريد شيئا مغايرا ، مثل ما يشربه أولئك الناس هناك...
- يا سيدي ، لن أستطيع أن أحضر لك شيئا تجهله ، ماذا إن لم يعجبك ؟
- إننا ندفع بالمقدم ، سأدفع أيا كان ، لكني أريد شيئا مختلفا...
- مثل ماذا؟
- لا أعلم الأسماء فقط فاجئيني...
نظرت لي مطولا ، ثم غابت قليلا ، و عادت بكأس من بيرة صفراء ...
قلت: ماهذا؟؟
قالت: ستلا... "
ضرب الرجل كفا بكف و أكد لي أنها لا تفهم في أصول و اتيكيت البارات ، قالها بلكنته الصعيدية ، و لكنه كان أكثر إقناعا من الفتاة في قلب لندن....
قارنت مقارنة عبثية ،فكرت أن هناك أصدقاء لي من شباب الفنانين الجدد، أو فتيان و فتيات الجامعة الأمريكية و ما عداها ، أشعرغالبا و أنا بينهم أنهم لا علاقة لهم بواقع هذه البلاد ، لا يعرفون شيئا عما حدث أو يحدث ، و الكل غارق في معاناته ، أفكاره الذاتية.. (و لا غبار على ذلك إطلاقا)
و لكن الغريب أن رجال البار هؤلاء ، أيضا ، لا علاقة لهم بما يحدث خارج هذا الباب ، العالم إن قام و نام ، فهم لازالوا هنا ، يطلقون النكات ، و يغيرون الموسيقى... و لكن الفرق الوحيد أن زملاء البار يعكسون شيئا منا جميعا..
ليس لأنهم من ماض بعيد ، على العكس فمنهم شبان و شابات ، و لكن لكل هذه التعددية ، و الاختلاف و القبول في آن واحد ، في مكان واحد... يتحدثون لغة هي خليط بين لغتي أنا و لغة أبي و أمي ، لغة سفهاء البلاد و أبطالها ، لغة الفتاة التي أحب ، و لغة الفتاة التي أكرهها ... يتحدثون العامية التي تتخللها الفصحي ، و فرنسية مفهومة ، و انجليزية غاية في التعقيد ، و ربما شذرات من أرمنية أو يونانية... و لا مجال للثقافة هنا..
روى أحدهم نكتة" صليب سيدنا محمد" الشهيرة ، فضحك الحضور على اختلاف دياناتهم و مشاربهم ، و رد آخر بنكتة نكاية في الأقباط ، و ضحك الجميع أيضا ، و الحق كنت أعرف أن نصف الجلوس على الاكثر مسلمين ، و النصف الآخر من ملل و نحل أخري ، و الحق لم أعرف أيهم من و أيهم من ...
قبل انصرافي في أحد المرات ، قال لي أحدهم ... درينك سريع يا أحمد بيه؟ (الكل بيه هناك) ... و صب لي سائلا ما لا أشربه ، رفعت الكأس و قلت في صحة البار.... لم يسألني أحد ماذا أعني ، لم يعلق أحد، فقط ، شربوا النخب في سلاسة